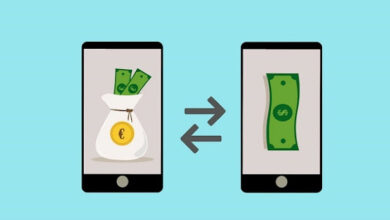مُوريتانيا في مُخيّلة جيرانها / أمم ولد عبد الله
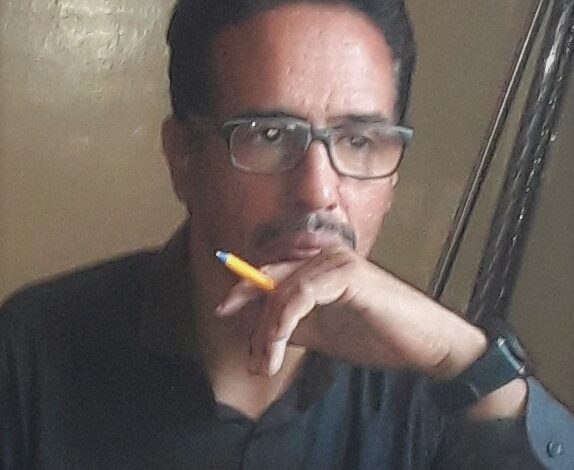
تحتاج الصُّور النَمطية في الغالب إلى رصيد من الغرائبية تمتزج فيه الأساطير ببعض الحقائق المبنية في الأساس على معايير قيمية، تستند في أحكامها إلى عناصر الاختلاف مع “الآخر” لتشكل مع مرور الزمن مجموعة من الحقائق، المُتجذّرة في اللاشعور، بهذه الأساليب تُنسج المجتمعات عن جيرانها، تصورات مقعدة ومركبة في -الآن ذاته-، تم بناءها عبر أجيال عديدة وخلال فترات زمنية مختلفة.
وإذا حاولنا تتبع كيفية تشكيل صورتنا في مخيلة المجتمعات المجاورة نجد أنها أخذت مظاهر عديدة، بدأت بنقل أخبار مجتمعنا عبر الرحالة والجغرافيين، كما حدث مع جيراننا في الشمال، أوعبر المبادلات التجارية المباشرة كما هو الحال مع كل من السنغال ومالي وغيرهما، وهنا لابد من التأكيد على أن المجتمع الموريتاني هو عبارة عن مجموعة من الإنثروبولوجيين الهواة بالمعنى الاجتماعي للإنثروبولوجيا، فمجرد التحية اليومية هي أسئلة غاية في الدقة، بحيث يمكننا اعتبارها، إجرائيا، استمارات شفهية مركزة لمعرفة التفاصيل اليومية لحياة الأفراد، هذه الخاصية سهلت على الغرباء معرفة الكثير من الأمور المتعقلة بالعادات والتقاليد وحتى بنظرتنا للمقدس، ولاشك أن تلك الانطباعات المأخوذة بوسائل بعيدة من التجريد ستُكوِّنُ صورتنا التي ستُحفظ في النهاية في ذاكرة مجتمعاتهم عبر مجموعة من الانطباعات الغير مُتناهية.
ففي سنة 1520م وصل الحسن الوزان الملقب بالأسد الإفريقي إلى واحدة من مدننا التاريخية، ووصف أهلها بأوصاف تبدو معيارية في معظمها، حين بدأ حديثه عن ساكنتها بقوله : “…غايةً في الخِسَّةِ ، إلاَّ أنَّهُمْ ظُرَفاءُ معَ الأجَانبِ”، هذه الملاحظة تصب في السياق نفسه الذي قدَّمه ابن بطوطة عن المدينة ذاتها، بعد أن أبدى استغرابه من بعض عاداتهم الاجتماعية. وهي الصورة التي تشكلت -على ما يبدو- في أذهان جيراننا الشماليين منذ القرن السادس عشر، وستتضح معالمها أكثر مع سبعينيات القرن الماضي، بعد هجرة العديد من الطلاب والمرضى وبعض السياح القادمين من البادية، فنمط لبساهم وعفويتهم الساذجة في التعامل مع واقع المدينة أكد للجيران الشماليين أنهم قادمون من مدن قوافل الملح، فالمعالم هي ذاتها، والعقلية لم تخرج كثيرا عن ذلك التصور المقيد بالجمود بحكم محاصرته بين تضاريس الزمان والمكان.
بين “الحِكْرَةِ” والشّفقة:
كان من المفروض أن تتغير معالم مدننا الكبرى مع الزمن، لكن تهالك بنيتها التحتية وفوضوية المرور فيها جعلها تبدو أشبه بالحواضر القديمة، ربما المتغير الوحيد فيها هو التلوث الخطير وتلك العربات والسيارات الحديثة التي يتصرف سائقوها بمنطق “آمَكْطَارْ”، لم يستطع الجيران فهم وضعية كهذه في دولة تمتلك من الموارد ما يجعلها محورا اقتصاديا مهما في شبه المنطقة، بالنظر لموقعها الجغرافي المتميز. والظاهر أن هذا التخلف الذي تجسده معالم العمران قبل الإنسان رسّخ صورة مشوشة لدى ساكنة دول المغارب مبنية على ثنائية الحِكْرةِ والشفقة، فهناك استحقار لشعب يملك موارد بهذا الحجم ، ومع ذلك لا يزال يراوح مكانه في قيعان التخلف والفقر. أما الشفقة فمصدرها تلك المفارقة التي تسجد مقولة بلد غني وشعب فقير، بمعنى أن غياب الإرادة جعل شعبا بأكمله يئن تحت وطأة معاناة يصعب استيعابها على كل من يفهم في أبجدية ترتيب الأولويات.
موريطانيا موريطانيا..!
يبدو أن كأس الأمم الإفريقية المنظم حاليا في ساحل العاج، وما شهدته من مفاجآت في، نظر البعض، أعاد هذا التعبير المركز-موريطانيا- إلى دلالته القديمة، فالاستغراب الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي وأساليبه الساخرة ” حتى موريطانيا”، ” خسرنا أمام موريطانيا يا ناس…” جسد تلك الثنائية التي تحدثنا عنها، وليست كلمة موريطانيا سوى أسلوب لبق يستخدم في أوقات السلم، لكنه يظل يحمل شحنة دلالية تصب في المعنى ذاته الذي تجسده تلك الثنائية في مخيلة دول المغربي عنا، وليس استبدال التاء طاء ناجم عن لحن كما يتوقع البعض، بل إنه صار علما بالغلبة على معانٍ بعينها لا تخلو من استخفاف صار جزءاً من ذاكرة جمعية ضاربة في القدم.
التجارة والبداوة:
لم يكن التجار الموريتانيون في الغرب الإفريقي عموماً يولون أي اهتمام لشكلهم الخارجي، تماما كما لم يعطوا أي أهمية للمجتمعات التي يتاجرون فيها، فقد ظلوا منغلقين على أنفسهم، لدرجة مثيرة للاستغراب، وهذا ما سماه أحد السوسيولوجين الأفارقة بالتناقض الفاضح، واصفا الأمر بقوله: “ففي الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء البداة الاستيلاء على كل ما في جيبك يظهرون لك كل الاحتقار من خلال معاملتهم البائسة..”.
لا يعبر هذا الانطباع عن ملاحظة إنسان متخصص، بقدر ما يشكل تصورا جماعيا، تكوَّن هو الآخر عبر الكثير من التراكمات أصبحت متحكمة في رسم صورنا في مخيلة مجتمعات غرب إفريقيا، وليست تسمية “نَارْكَّنَّارْ” أو البيظان البدو سوى ترسيخ لحقل مفاهيمي من السخرية، نلمسها بوضوح من خلال الكوميديا السنغالية عن البيظان البدو، فضلا عن الكثير من القصص المكتوبة في المجال، ناهيك المرويات الشفهوية التي أصبحت مصدر إلهام للكثير من هواة الكتابة، والحق أن معظم دول الغرب الإفريقي لا يسلم تراثها غير المادي من مسميات ذات دلالات قد حية لوصف الموريتانيين ، كما هو الحال مع غينيا بيساو الذين يطلقون علينا ” نارْكابرًهْ”، أو بيظيان الغنم، ولا يمكن عزل الوصف المستخدم في ساحل الحاج للموريتانيين عن هذا السياق les boutiquiers.
صحيح أن ثمة صوراً ناصعة للشناقطة في المشرق العربي عموما، لكن المخيلة الجماعة لا تحتفظ إلا بما قدمه الرحالة العرب وبعض القنوات التلفزيونية، ويكفي دلالة على هذا سؤال أحد الصحافة المصرية في واحدة من أشهر القنوات مستغربا من كون موريتانيا تتكلم العربية، “أهل موريتانيا يتكلمون العربية”؟… المحير في الأمر أن سؤالا كهذا يأتي بعد مضي أكثر من قرن من الزمن على رحيل محمد محمود ولد اتلاميد التركزي، (1904 ت)، الذي درّس أهم أساتذة اللغة العربية في مصر .
عموما نحن وحدنا من يُحدد صورتنا في مخيلة جيراننا وغيرهم، لكن تغييرها يحتاج نقلة نوعية، فالانطباعات الراسخة في ذاكرة المجتمعات تحتاج بالضرورة إلى سلسلة من الصَّدمات المذهلة والمبهرة، كي يتسنى لها تشكيل نمط آخر يُحدث قطيعة بستيمولوجية مع ترسبات لا تزال عصية على التغيير نتيجة لعوامل كثيرة، وأخشى أن تُنقل دلالة مفاهيم مثل موريطانيا و”نار كنار” إلى أمريكا الشمالية بعد موجة الهجرة الجديدة، خصوصا وأن ظاهرة التسكع الليلية في شوارع الحجاز وتهامة وتأبَّطَ ملفاً في الخليج بهدف تسويق الوهم، رسخ المفاهيم ذاتها في مجتمعات عربية، نأمل أن لا تتحول عدوى انطباعات المخيلة إلى ظاهرة كونية تحمل تسميته متلازمة موريطانيا…